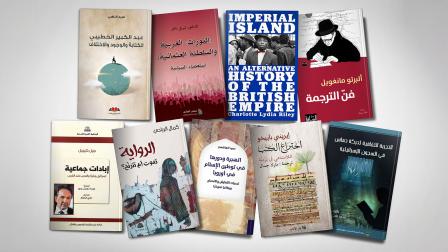تأتي ندوة دورية "تبيّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، التي انطلقت أمس وتُختَتم اليوم في الدوحة تحت عنوان "قضايا في فلسفة الأخلاق المعاصرة"، في سياق تركيزها خلال السنوات الثلاث الماضية على موضوعات الفلسفة العملية المتمثلة في الفلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاقية.
في كلمته الافتتاحية، قال رجا بهلول، رئيس تحرير "تبيّن"، الفصلية التي يصدرها "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة، إن ندوة العام الماضي طرحت موضوع الفلسفة السياسية المعاصرة المصيرية لدى الفرد والجماعة، بوصفها أبرز مجالات الفلسفة العملية. ولكن موضوع الندوة لهذا العام يطرح الفلسفة الأخلاقية بما تستحق من أهمية، حتى وإن كانت الفلسفة السياسية تحظى باعتراف عام بمكانتها، ومن ذلك، كما يضيف بهلول، أن الأخلاق كانت ولا تزال تشكل حُكماً معيارياً على السياسة.
المشاعر والتأسيسانية
في الجلسة الأولى من اليوم الأول، عاينت مشاركة بهلول، بعنوان "المشاعر والتأسيسانية (Foundationalism) في الأخلاق وحقوق الإنسان"، ثلاثة مشاريع فلسفية لبناء هذه الحقوق، الأولى التأسيس الديني، أو المرتبط بالفضيلة، ونجد معالمه المبكرة في محاورات سقراط التي صاغها أفلاطون، ومنها محاورته مع يوثيفرو، والتي تتناول قبح وحسن الأخلاق، أو بلغتنا الحديث أخلاقية وعدم أخلاقية الفعل، ووفق ذلك التأسيس فإن الأخلاق تأتي بأوامر الآلهة ونواهيها.
الحداثة الأخلاقية تنتصر للعقل السياقي وليس للعقل المجرد
أما المشروع الثاني، فقال إنه ما زال ذا شأن كبير في مساعي وضع الأخلاق على أساس واقعي صلب، وهو يتمثل في "النفعية" التي ترى أن ما نعتبره حقاً من حقوق الإنسان، كالحق في الأمن والمعيشة الكريمة، هو تحديداً ما فيه نفعٌ للإنسان. والثالث ما أتى به أنصار الكانطية في فلسفة "الواجب الأخلاقي"، حيث تُبنى الأخلاق على أمر قطعي غير مشروط، وحيث إن الإنسان قيمةٌ بحد ذاته.
وقال إن النظريتين النفعية والكانطية كانتا وما تزالان الأكثر شيوعاً في مجال التنظير للأخلاق والحقوق. بيد أن ثمة منافساً أقل شيوعاً لهاتين النظريتين، ألا وهو نظرية "المشاعر الأخلاقية"، باعتبارها نوعاً آخر من التأسيس يعود عهده إلى ديفيد هيوم وآدم سميث، إذ باتت هذه النظرية تحظى بشعبية أوسع في الوقت الحاضر، بعد أن تلقت دعماً من كتّاب مشهورين في أواخر القرن العشرين وفي القرن الحالي أيضاً، منهم ريتشارد رورتي ومارثا نوسباوم وأنيت باير.
وأشار بالتحديد إلى رورتي الذي دعا إلى تجاوز المشاريع الثلاثة التأسيسانية بما قد يكون لروح ما بعد الحداثة أثر في هذا، وهي المعروفة برفضها السرديات الشاملة. وإذا كان الإنسان حصيلة تطور طبيعي جعل منه كائناً اجتماعياً "بلغ مبلغاً عظيماً بحيث ما عاد يمكن مقارنته بأي كائن حي آخر"، فإنه أيضاً، كما أضاف، كائن سيكولوجي لديه اللغة والقدرة على التعلم والتفكير.
أما المشاعر الفردية والجماعية، ففي ملاحظة مبدئية، إنها نبعت من نزعة لكل ما من شأنه أن يعرّض حياة الفرد للخطر ومن التعاطف مع الآخر، ما بزغت منه الحياة الأخلاقية، وقوّت الحياة الاجتماعية وحقوق الإنسان. هذه القدرة على التعاطف، كما أشار، انتبهت لها مارثا نوسباوم بوصفها أساساً أخلاقياً قبل أن تتبلور في أعراف وقوانين.
المسألة الأخلاقية عند لارمور
قدم الزواوي بغورة، أستاذ الفلسفة الغربية المعاصرة في "جامعة الكويت"، ورقته بعنوان "الحداثة والمسألة الأخلاقية عند الفيلسوف تشارلز لارمور". وقرأ المتحدث ما قدمه الفيلسوف الأميركي في مجموعة من نصوصه التي حاول فيها تشخيص مظاهر المسألة الأخلاقية في عصر الحداثة، والبحث في الحد الأدنى لأرضية أخلاقية حداثية تصارع ضد أخلاق ما قبل الحداثة باسم الجماعة والتراث، وأخلاق ما بعد حداثية باسم الفردية والمتعة والحرية.
وقفت الورقة على المرتكزات النظرية الفلسفية والقيم الأخلاقية الحداثية التي طرحها هذا الفيلسوف، وقارنتها بالنقاش الفلسفي الأخلاقي المعاصر، سواء على مستواه الفكري العالمي والغربي تحديداً، أو على مستوى الفكر العربي المعاصر الذي يسعى لبلورة منظور أخلاقي يتناسب ووضعيته الحضارية والنهضوية.
وقال إن لارمور لا يتردد في الإقرار بأن فلسفة الأخلاق الحديثة تتلاءم مع سمات الحياة الحديثة المختلفة عن المجتمع القديم، وعليه لا يمكن فهمها إلا في سياقها. وفرّق المحاضر بين الفضيلة والكمال الأخلاقي والخير الأسمى كما عند أفلاطون وأرسطو، وفكرة الإلزام الأخلاقي كما في الأخلاق الحديثة التي تحقق مبدأ الكونية والكلية.
وختم بأن لارمور فحص الحداثة الأخلاقية نقدياً، لكن رغم ذلك، فهو يؤكد أن الحداثة تصر على ضرورة التفسير الطبيعي الخالص للطبيعة وعلى الفهم الإنساني لها، وكذلك الانتصار للعقل السياقي وليس للعقل المجرد أو الصوري، وإذا كانت نظرية الأخلاق الحديثة مطبوعة بالاختلاف فإن لارمور يؤكد على ضرورة الاختلاف المعقول الذي يتمثل في مفهوم أساسي عنده وهو مفهوم أخلاق الحد الأدنى.
تمثُّلات الأنموذج الأخلاقي
تلاحظ نورة بوحناش، أستاذة فلسفة الأخلاق والقيم بـ"جامعة قسنطينة 2" في الجزائر، في الجلسة الثانية من الندوة، أن الخطاب الأخلاقي العربي المعاصر مقولب ولم يفهم طبيعة الحداثة، وأن هناك نكوصاً تراثياً يرى الحل في القرون الهجرية الأولى ولا يريد القيام بعملية تأويلية جديدة تفتح آفاقاً لمشروع أخلاقي جديد، ومقابل ذلك فإن المشروع الحداثي "لم يبدع" بمعنى أن تجاوز النسق المفروض علينا لتأسيس قراءات جديدة من منطلقاتنا الذاتية.
طرحت ورقة الباحثة بعنوان "تمثلات الأنموذج الأخلاقي فـي خطاب الفكر العربي المعاصر: قلق في سوابق الحداثة" سؤال "هل نحن في مجتمعاتنا العربية نفكر في نظامنا الأخلاقي أم نفكر في نظام آخر؟".
وكما وصفت الخطاب الأخلاقي بالمقولب، أضافت إليه وصف التفكير في ذات متخيلة لا حقيقية، "ذات تنتمي إلى الماضي نصد به الجديد، وقادم من أوروبا، نتبعه حتى وصلنا إلى خطاب ما بعد الحداثة وقد تم تدجين الإنسان العربي الذي لا يرى إلا ما يأتي من الغرب، وهو الغرب الاستعماري الإحلالي ولكن الذي أنتج خطابه الأخلاقي في سياقه هو".
نكوص تراثي يرى الحل في القرون الهجرية الأولى ولا يريد القيام بعملية تأويلية جديدة
ومباشرة نقلتنا المحاضرة إلى ميشيل فوكو الذي لم يوارب برفضه أن يدخل تاريخ المجتمعات الأخرى في الإبستيم الغربي لأنه يرى أوروبا مختلفة عن الإبستيميات الأخرى، لذلك ترى بوحناش أنه لا يمكن الحديث عن فكر أخلاقي عربي معاصر في مظان هذه الأنَوَات القديمة غير الصالحة اليوم وأنوات مفتعلة ومتخيّلة ومستوردة وهي الحديثة.
نقد أخلاق التراث
أربعة كتب قرأها رشيد الحاج صالح، مدير تحرير دورية "تبين"، لتكون مجال محاججته المعنونة "نقد أخلاق التراث في الفكر العربي المعاصر"، وهي "العقل الأخلاقي العربي" لمحمد عابد الجابري، و"الصحوة والإصلاح والخيارات الأخرى" لرضوان السيد، و"بؤس الدهرانية.. النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين" لطه عبد الرحمن، و"الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي" لوائل حلاق.
مبرّر استحضاره هذه النماذج، وقد صدرت جميعها خلال العقدين الأخيرين، هي أنها تعاين الأزمة الأخلاقية في التراث وترى الحلول أيضاً موجودة في هذا التراث.
ورأى الباحث أن تضخّم التوجه التراثي في الفكر الأخلاقي العربي المعاصر هو المسؤول عن حالة التغريب، التي يعانيها هذا الفكر، قاصداً من هذا التغريب أن هناك تهويلاً لعلاقة الأخلاق بالتراث، وتضخيماً لربطها بالهوية، وذلك على حساب امتدادات الأخلاق السياسية.
فالفكر الأخلاقي العربي الملتف حول التراث والهوية، والذي نسميه "أخلاق التراث"، مبني على مقاربات ذات شواغل ثقافية/ تراثية ترى أن الأخلاق في النهاية تابعة للتراث أو أنها شكل من التدين، وأنها مرتبطة بالهوية، مثلما نجدها تدرس الأخلاق بوصفها قضية تخص النخب أكثر مما تعني للناس العاديين. وبالتالي فهي أخلاق مغتربة عن الناس وما يحدث في المجتمع من تغيرات.
ووجد لزاماً أن يتساءل: هل ما زالت الأخلاق، ولا سيما الأخلاق السياسية، أخلاق طاعة وتربط المُلك بالدين، أم أنها تتمحور حول العدالة والمساواة؟ وهل همّ العربي اليوم فهم مفهوم العدل في كتب علم الكلام والتراث، أم همّه أولاً العدل السياسي والاجتماعي؟
ووفق ما قال، فإن مسلَّمة أننا نعيش بشكل دائم في أزمة أخلاق هي أطروحة مزيّفة لأن الأصل أزمة سياسية، وإن الفرد العربي المعاصر لم يجد في الثورة فتنة كما تقول كتب التراث ولا الخروج على الحاكم خصماً من قيمه الدينية.
وانتهى إلى القول إن أخلاق التراث تسعى إلى "ترسيخ أخلاق الطاعة وتتنكر لأخلاق الكرامة والاعتراف، وتنكر على الإنسان العربي أن يعيش عصره، وتطلب منه أن يكون بلا شخصية إنسانية ولا أن يطلب العدالة والمساواة".
خصخصة الأخلاق
في الجلسة الثالثة لليوم الأول، بدأت ورقة عبد الرزاق بلعقروز، أستاذ فلسفة الأخلاق والقيم بـ"جامعة سطيف 2" في الجزائر، التي تحمل عنوان "ما بعد الأخلاق: من المعنى التحليلي إلى التحول الثقافي"، بشرح الاتجاه التحليلي في فلسفة الأخلاق كما عرف نضوجه المنهجي مع جورج إدوارد مور، في كتابه "المبادئ الأخلاقية" (1903)، وكما تؤول بعض القراءات أن النصوص التحليلية لإدوارد مور قد أسهمت في توجيه المباحث الأخلاقية نحو فكرة الاستقلال الذاتي.
وفضلاً عن هذا المدخل المنهجي قاربت ورقة بلعقروز ما بعد الأخلاق، التي ترادف في معناها مفردات مثل: ما بعد الواجب أو العتبة الثانية من العلمنة الأخلاقية، والتي من سماتها: الشخصنة وهجر الإلزام بخاصة العقلاني منه، وتحول الوعي من الوعي الذاتي إلى النرجسي. وبيّن الباحث أن ما بعد الأخلاق لا تتغذى على إلزامات الواجب، أو منفعة المجتمع، أو التطابق مع الفضيلة، بل إن الرفاهية وحركة الحقوق الذاتية والقيم الفردية هي المعاني التي تغذي ما بعد الأخلاق.
وأضاف أن سؤال المتعة يعني اضمحلال الفضاء العام وخصخصة الفعاليات الأخلاقية. وإذا كانت العلمنة الأخلاقية في عتبتها الأولى هي تحرير الأخلاق من الأسس الدينية، فإن العتبة الثانية ذهبت إلى سؤال/ كيف نحقق الرغبة ونتجنب الألم قدر المستطاع؟
وكما تستلهم النظريات والمفاهيم أساطير قديمة فإن الذات التي تخرج على التأسيس الأخلاقي ذات نرجسية، نسبة إلى أسطورة نرسيس، وليست "أنا ديكارت" التي أغضبت الكنيسة "أنا أفكر إذاً أنا موجود".
وطرح الباحث في عجالة ما يسمى "الذكاء الأخلاقي والمطبق" ومن ذلك يعتني هذا الحقل بالنتائج النافعة للإنسان أكثر من اعتنائه بالنوايا الخالصة، ويجنح إلى الإصلاحية أكثر من المثالية ويحث على المسؤولية أكثر من الزجر، ويبحث عن توافقات معقولة وإجراءات عادلة تخفف من الأمر والبعد الأنوي، وفي النهاية قال إن التربية الاجتماعية تعيد دور الفضاء العمومي، لأنه بقدر الانفصال عنه تقع الأزمة.
جدلية الفردي والمؤسّساتي
أثارت أحداث الربيع العربي العديد من الأسئلة السياسية، لكن صياغة هذه الأسئلة كانت أخلاقية في الغالب. هل يمكن الحكم على السياسات من منطلق أخلاقي؟ هل يمكن ممارسة معارضة أخلاقية في دولة تمنع الاعتراض السياسي؟
بحسب أحمد نظير الأتاسي، أستاذ التاريخ في "جامعة لويزيانا التقنية"، "الأخلاق والسياسة: جدلية الفردي والمؤسساتي" فإن هذه الأسئلة، إمّا تضع أفراداً في مواجهة مؤسسات ودول أو تضع مؤسسات في مواجهة مؤسّسات أخرى.
من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة، انطلقت ورقة الباحث من مستويات كولبرغ للتطور الأخلاقي في المجتمعات البشرية. ومن ثم عرض شرح علم النفس التطوري لهذه المستويات وصولاً إلى الضمير الفردي (الأنا العليا، وهو المستوى الرابع). لكنّ ذلك العلم فشل في شرح المستويين العلويين (الخامس والسادس). ولذلك حاججت ورقته بأنه لا يمكن وجود المستويين الأخيرين إلا من خلال انبثاق مؤسسات محلية ودولية (مثل الدستور ومؤسسات الدولة وشرعة حقوق الإنسان) وأن المؤسسات باعتبارها منبثقات اجتماعية تحمل نواة قواعدها السلوكية الخاصة، وأنه يمكن توليد أخلاق مؤسساتية لها ضوابطها وروادعها.
ومن وجهة نظره، فإن تركيبة الأخلاق "إذا فكرنا من مبدأ تأسيس" تقتضي بأن هناك معضلة أخلاقية مستمرة، ولذا نادى بصياغة سؤال جديد "لماذا نحن البشر مصممون بطريقة تجعلنا نعتقد بوجود هذه المعضلة؟". لا بد أن لوجود المعضلة وظيفة اجتماعية، وهو ما جعله يقرر بأن الأخلاق ليست مسألة فلسفية بل اجتماعية ولا يمكن الوصول إلى أي نتيجة من خلال مفاهيم مطلقة، بل بربطها بواقع.
وفي الختام رأى أتاسي أن الأخلاق عملية تعلم وليست مبادئ، وأن القانون صيغة مكتوبة عن الأخلاق، موضحاً أن السلطة الناظمة عندما تريد أن يتحقق شيء تجعله قانوناً وحينما لا تريد تجعله أخلاقياً، ذلك لأن الأخلاق مطواعة.